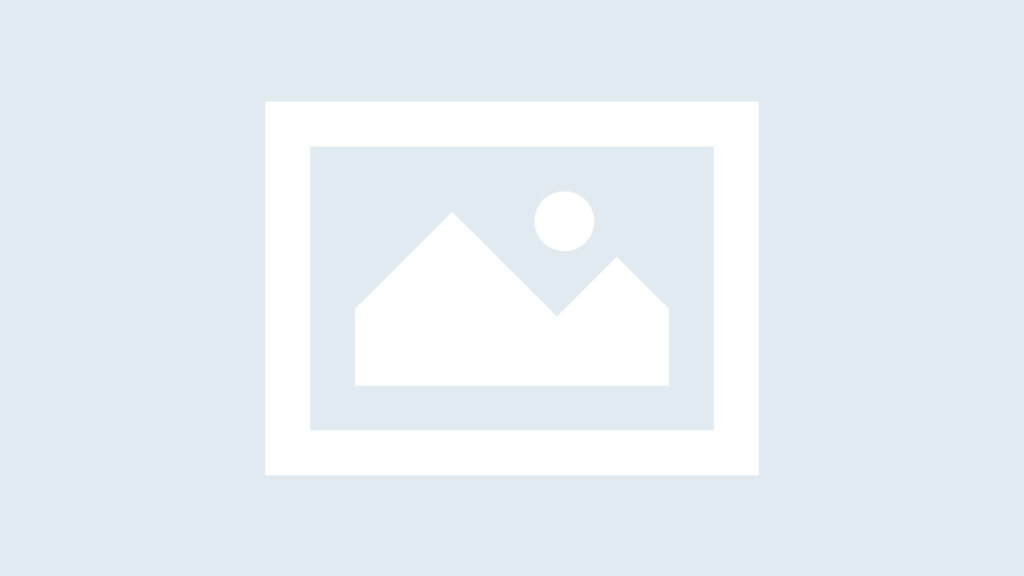1- مقدمة:
يسعى هذا المقال إلى قراءة تاريخ أوروبا الحديث بوصفه مسارًا طويلًا من التحولات التي كشفت عجز القارة عن امتلاك قرارها الاستراتيجي بصورة مستقلة. فمن انهيار الإمبراطوريات في الحرب العالمية الأولى، إلى دمار الحرب الثانية، ثم الارتهان الأمني للمظلة الأميركية خلال الحرب الباردة، تشكّلت بنية أوروبية تقوم على التعويض عن الضعف عبر التحالف لا عبر الاستقلال.
ومع نهاية الحرب الباردة وتعميق التكامل الأوروبي، بدا أن القارة تقترب من نموذج وحدوي فريد، غير أن هذا التكامل ظلّ اقتصاديًا وقانونيًا أكثر منه دفاعيًا واستراتيجيًا. وقد أعادت أزمات العقدين الأخيرين، من التوسع الأطلسي شرقًا إلى حرب أوكرانيا وتصاعد التوتر عبر الأطلسي، طرح سؤال القدرة الأوروبية على حماية ذاتها بعيدًا عن الإرادة الأميركية. ومن هنا، يحاول المقال إثبات أن البحث الأوروبي الراهن عن «الاستقلال الاستراتيجي» ليس خيارًا طارئًا، بل نتيجة تاريخ طويل من التبعية الأمنية التي لم تُحسم بعد.
2- أوروبا والحرب العالمية الأولى: سقوط الامبراطوريات
في صيف 1914، تحوّل اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند في سراييفو من حادثٍ سياسي محدود إلى شرارة أشعلت شبكة معقّدة من التحالفات والتوترات الأوروبية. كانت القارة تعيش سباق تسلّح وصراعًا على النفوذ والأسواق، بينما بدت الإمبراطوريات الكبرى قوية في ظاهرها، لكنها مثقلة بتصدعات قومية واجتماعية في باطنها. ومع اندلاع الحرب، تحولت الجبهات إلى خنادق ممتدة، وصار الموت جماعيًا بفعل الأسلحة الحديثة، في حرب استنزفت الدول وجيوشها واقتصاداتها بلا مكاسب تُذكر على الأرض.
كانت الإمبراطورية الروسية أول المنهارين؛ بحسب ما ذكرته مارغريت ماكميلان وهي مؤرخة كندية في كتابها Six Months That Changed the World، فالهزائم ونقص الغذاء وسوء الإدارة فجّرت ثورة 1917 وأسقطت حكم القياصرة، لتدخل البلاد مسارًا جديدًا انتهى بقيام الاتحاد السوفيتي. وفي النمسا-المجر، انفجرت التناقضات القومية مع طول الحرب، فتفككت الإمبراطورية إلى دول مستقلة، وانتهى حكم آل هابسبورغ. أما الدولة العثمانية، فقد خرجت مثقلة بالخسائر، لتوقّع اتفاقيات قاسية أدّت إلى تفكيك أراضيها وإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط. وفي ألمانيا، عجّل الحصار والخسائر باضطرابات داخلية أجبرت القيصر على التنازل، وجاءت معاهدة فرساي بشروط مهينة زرعت بذور انتقامٍ لاحق.
لم تكن الحرب مجرد مواجهة بين دول، بل نقطة تحوّل أنهت عصر الإمبراطوريات التقليدية وفتحت الباب أمام دول قومية جديدة، فيما خلّفت أزمات سياسية ونفسية عميقة. لقد أثبتت أن الحروب الكبرى لا تنتهي بتوقيع المعاهدات، بل تمتد آثارها لعقود، وأن القوة حين تنفصل عن العدالة والحكمة قد تسرّع نهاية عالمٍ بأكمله.
3- أوروبا والحرب العالمية الثانية-الدمار والحاجة الى الوحدة :
تحت وطأة التهديد النازي، أصبح العالم على شفير حرب مدمرة: هتلر خطط للحرب منذ ١٩٣٥، بينما سبقتها اليابان بالعدوان على الصين عام ١٩٣١، وعجزت عصبة الأمم عن وقف توسعها. السياسة الغربية أخفقت في مواجهة التهديد الألماني، حيث اعتمدت فرنسا على خط ماجينو، وتجاهلت تحذيرات ديغول بضرورة تحديث الجيش لمواجهة الأسلحة الحديثة. في ظل سياسة التهدئة، راهنت بريطانيا وفرنسا على المشكلات الداخلية والاقتصادية لهتلر وموسوليني لردع عدوانهما، فاتُخذت قرارات أعاقت استعداد أوروبا للحرب.
بدأت الحرب العالمية الثانية بغزو ألمانيا لبولندا في الأول من سبتمبر ١٩٣٩، بسرعة هائلة وبخسائر محدودة، واستسلمت وارسو في ٢٨ سبتمبر، ما أدى إلى تقسيم بولندا بين ألمانيا وروسيا وفق الاتفاق السري في المعاهدة الألمانية-الروسية. وأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا وعبأتا جيوشهما على الحدود الفرنسية، لكن الخطط الدفاعية مثل خط ماجينو لم تغطِ كل الحدود ولم تمنع التقدم الألماني. وفي الوقت نفسه، عبرت القوات السوفيتية الحدود الشرقية لبولندا ووسّعت روسيا نفوذها على دول البلطيق وفنلندا، ما أدى إلى تغيير خريطة شرق أوروبا ومهد لمراحل لاحقة من الحرب.(هذا ما ورد في كتاب أوروبا في القرنين ١٩ والـ ٢٠ الجزء الثاني الصادر عن مؤسسة سجل العرب القاهرة ١٩٦٧ ص٤٨٦/٤٨٧).
في ربيع 1940 شنت ألمانيا هجومًا واسعًا على شمال وغرب أوروبا، فتجاوزت خط ماجينو واحتلت الدنمارك والنرويج وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، ما أدى إلى انهيار الدفاعات الفرنسية وحصار القوات البريطانية والفرنسية في دنكرك، ثم سقوط باريس في 14 يونيو وقيام حكومة فيشي، بينما انتقل ديغول إلى لندن لقيادة «فرنسا الحرة» بمساندة بريطانيا لمنع استيلاء الألمان على الأسطول الفرنسي.
وانتهت الحرب لاحقاً بهزيمة ألمانيا في أوروبا واستسلام اليابان في آسيا، لتُطوى صفحة واحدة من أكثر مراحل التاريخ دموية. انهار «الريخ الثالث» بانتحار هتلر وسقوط ألمانيا النازية، ثم انتهت الحرب في آسيا بعد ثلاثة أشهر بإلقاء القنبلة الذرية. خلفت الحرب العالمية الثانية دماراً هائلاً في أوروبا، إذ تحطمت المدن والمصانع والبنية التحتية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، وتعرضت بريطانيا لتخريب واسع في مدنها الصناعية، بينما شهد الاتحاد السوفيتي تهديم المدن وتشريد الملايين وتدمير المصانع والمزارع ونهب الثروات الحيوانية. اجتماعياً، نتج عن ذلك ملايين المشردين واللاجئين والأسرى، مع تحديات كبيرة لإعادة توطين السكان وإعادة أكثر من عشرة ملايين عامل أُجبروا على العمل في ألمانيا.
دولياً، أنهت الحرب ما تبقى من نظام القوى الأوروبية التقليدي الذي تزعزع منذ الحرب العالمية الأولى. تراجع الدور الفرنسي كقوة كبرى، وضعف النفوذ البريطاني وعجزت لندن عن مواصلة سياسة توازن القوى كما في السابق. في المقابل، برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قوتين عظميين تتنافسان على قيادة العالم، مدعومتين بالتفوق في أبحاث الذرة والتقدم التكنولوجي. (من كتاب دراسات في تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ١٨١٥-١٩٥٠ ، عبد العزيز عمر ومحمد علي القوزي -دار النهضة العربية -ص ٤٠٠/٤١٠/٤٠٢.
3- أوروبا والحرب الباردة: أوروبا الغربية تحت المظلة الأميركية.
تُظهر أصول الحرب الباردة في أوروبا بين عامي 1945 و1950 كيف تحوّل «تحالف الضرورة» بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى صراع مفتوح فور زوال العدو المشترك. فقد كان هذا التحالف، منذ بدايته، مثقلًا بالريبة الأيديولوجية والتاريخية؛ إذ نظرت واشنطن إلى النظام السوفييتي بوصفه تهديدًا فكريًّا وسياسيًّا، بينما رأى الكرملين في الغرب قوة رأسمالية سعت إلى محاصرته منذ الثورة البلشفية. ورغم التعاون العسكري الواسع بعد عام 1941، ظلت الخلافات كامنة حول توقيت فتح الجبهة الثانية، وشروط السلام مع ألمانيا، ومستقبل أوروبا الشرقية.
ومع تولي ترومان الرئاسة وتعزز الثقة الأمريكية بامتلاك السلاح الذري، اتجهت السياسة نحو مزيد من التشدد، وتجلّى ذلك في «البرقية المطولة» لكينان وهو دبلوماسي ومفكّر استراتيجي أميركي، يُعدّ الأب النظري لسياسة الاحتواء ، وخطاب تشرشل عن «الستار الحديدي»، حيث تشكلت رؤية غربية تعتبر موسكو قوة توسعية تستفيد من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية لنشر الشيوعية. وبالاستناد إلى الأرشيف الوطني الأمريكي (United States National Archives and Records Administration).
ففي عام 1947 بدأت سياسة الاحتواء عمليًّا عبر «عقيدة ترومان» ومشروع مارشال لدعم أوروبا الغربية اقتصاديًّا ومواجهة صعود اليسار، بينما ردّ ستالين برفض إشراك دول الشرق الأوروبي وتشديد قبضته عليها وتأسيس «الكومينفورم» وهو عبارة عن مكتب يضم الدول الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفيتي.
تزامن ذلك مع تحوّل حاسم في الموقف من ألمانيا، إذ رأت واشنطن أن نهضة أوروبا تتطلب إحياء الاقتصاد الألماني الغربي، ما دفع نحو تقسيم فعلي للبلاد. وبلغ التوتر ذروته في حصار برلين (1948–1949) الذي انتهى بتكريس الانقسام وقيام دولتين ألمانيتين. وفي السياق نفسه تأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949، رابطًا أمن أوروبا الغربية بالولايات المتحدة. وهكذا تبلورت حدود الحرب الباردة في أوروبا، وانقسمت القارة إلى معسكرين متواجهين، في ظل نظام دولي جديد تقوده قوتان عظميان تتنازعان النفوذ سياسيًّا واقتصاديًّا وأيديولوجيًّا دون مواجهة عسكرية مباشرة.
4- أوروبا بعد الحرب الباردة التكامل التحديات والتحولات
شهدت أوروبا مسارًا مزدوجًا اتسم بتعميق التكامل من جهة، وتصاعد تحديات بنيوية وسياسية من جهة أخرى. وبالاستناد إلى ما ورد على موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تحليل After the Berlin Wall: Europe’s Struggle to Overcome Its Divisions، فقد فتح انهيار الجدار الباب أمام إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة، مع توحيد ألمانيا، وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات مستقلة، وذلك بعد ان تراكمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وصعود الحركات القومية وانقسام تشيكوسلوفاكيا سلميًا، مقابل انهيار دموي ليوغوسلافيا قاد إلى حروب وتطهير عرقي أعادا طرح أسئلة جوهرية حول السيادة والتدخل الدولي وحقوق الإنسان.
في هذا السياق، تسارعت وتيرة المشروع الأوروبي الذي تعود جذوره إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، فتأسس الاتحاد الأوروبي رسميًا بموجب معاهدة ماستريخت (1992) وتكرّس هيكله بمعاهدة لشبونة (2007). قبلت الدول الأعضاء مبدأ تقاسم السيادة، وأُقرت الحريات الأربع وفضاء شنغن، بما جعل من الاتحاد نموذجًا فريدًا لتكامل إقليمي يتجاوز الدولة الوطنية. ومع توسع الاتحاد شرقًا بين عامي 2004 و2007، بدا أن حلم «أوروبا موحدة وحرة» يقترب من التحقق، غير أن هذا التوسع نفسه نقل مركز الثقل السياسي شرقًا وأثار توترات داخلية جديدة.
برزت ألمانيا، بعد إعادة توحيدها، كالقوة الاقتصادية الأبرز في القارة، ما عزز نفوذها داخل مؤسسات الاتحاد، لكنه ولّد حساسيات تاريخية وسياسية، خاصة مع فرنسا التي شكّلت معها تقليديًا محور القيادة الأوروبية.
أما على الصعيد الأمني، فقد أعاد تفكك يوغوسلافيا والتدخلات العسكرية لحلف الناتو طرح مفهوم «مسؤولية الحماية» فوق مبدأ السيادة التقليدية. ومع توسع الناتو شرقًا، تصاعد التوتر مع روسيا التي رأت في ذلك تهديدًا مباشرًا لنفوذها. ومع وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، اتخذت موسكو مسارًا تصادميًا مع الغرب، تجلى في حرب جورجيا (2008)، وضم القرم والتدخل في أوكرانيا (2014)، وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط، ما أعاد إحياء مناخات الحرب الباردة وأجبر أوروبا على إعادة التفكير في أمنها الدفاعي وعلاقتها بالولايات المتحدة.
شهدت العلاقة عبر الأطلسي بدورها تقلبات ملحوظة؛ إذ تراجعت الثقة الأوروبية بالقيادة الأمريكية، خاصة في عهد دونالد ترامب، الذي شكك في جدوى الناتو وفرض رسومًا جمركية على الحلفاء، ما دفع قادة أوروبيين إلى التفكير جديًا في بناء قدرة دفاعية مستقلة.
5- أوروبا والصراع على اوراسيا –قلب العالم
يشكّل الصراع على أوراسيا مواجهة جيوسياسية وجيواقتصادية بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، للسيطرة على «قلب العالم» الغني بالموارد والطاقة. تسعى موسكو عبر مشروع «أوراسيا الكبرى إلى كسر الهيمنة الأطلسية، فيما يعمل الغرب على تطويق روسيا ومنع تقاربها الآسيوي، مما يجعل المنطقة ساحة تنافس دائم بين قوى البر والبحر.
تُعدّ أوراسيا الكتلة الجغرافية التي تضم أوروبا وآسيا «قلب العالم» جيوسياسياً، لامتدادها من الأطلسي إلى الهادئ واحتضانها القسم الأكبر من الموارد والطاقة والسكان والإنتاج العالمي. وتتمحور الإشكالية حول التوسع الأوروبي شرقاً في مقابل التوجه الأوراسي الروسي، وما يخلّفه ذلك من إعادة تشكيل لموازين النفوذ، مع تأثيرات إضافية للانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
في الفكر الاستراتيجي الغربي، ميّز الخبير في الجغرافيا السياسية نيكلوس سبيكمان وهو عالم سياسة واستراتيجي اميركي بين «القلب القاري» الذي تمثله روسيا و«أرض الحافة» الساحلية الغنية بالممرات والموارد، حيث ركز على أهمية الجغرافيا السياسية في تحديد القوة العالمية.
وبعد الحرب الباردة، أصبحت أوراسيا مركز تنافس مباشر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، مع بروز تحالفات استراتيجية تتركّز في هذا الفضاء.
في المقابل، طرحت روسيا مشروع «أوراسيا الكبرى» والاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمواجهة الهيمنة الأطلسية، عبر اتحاد جمركي وفضاء اقتصادي مشترك مع بيلاروسيا وكازاخستان، مستندة إلى رؤية تعتبر روسيا قوة أوراسية ذات امتداد حضاري وجغرافي.
أدّت تحولات عام 1989 إلى انتقال دول شرق أوروبا نحو الديمقراطية واقتصاد السوق بدعم غربي، مدفوعة بدافعين رئيسيين: الهوية القومية والازدهار الاقتصادي، ما عجّل بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ضمن موجات توسع متتالية (2004، 2007، 2013) وفق شروط كوبنهاغن ونقل المعايير الأوروبية إلى الدول المرشحة.
عزّز الاتحاد الأوروبي حضوره عبر سياسة الجوار (2003) والشراكة الشرقية (2009) مستخدماً أدوات تمويل ومساعدة متعددة لخلق «حلقة أصدقاء» مستقرة حوله، وهو ما أثار توتراً ضمنياً مع روسيا التي رأت في ذلك تمدداً لنفوذ الاتحاد في مجالها الحيوي.
غير أنّ هذه الاستراتيجية أفرزت تحديات داخلية، أبرزها مخاوف الهجرة والجريمة المنظمة والتباينات الثقافية، وصعود اليمين المتطرف. ثم جاء الانسحاب البريطاني ليضيف أبعاداً جديدة تتعلق بتماسك الاتحاد، وسط مخاوف من «عدوى الانسحاب» وتداعيات اقتصادية وسياسية داخل بريطانيا نفسها.
وهكذا غدت أوراسيا محور الصراع العالمي بعد الحرب الباردة، حيث يتقاطع المشروع الأوروبي التوسعي مع الطموح الأوراسي الروسي، في ساحة توازن دائم بين قوى البر والبحر، تعيد باستمرار رسم خرائط النفوذ الدولي. هذا ما ورد في جزء من دراسة نُشرت في مجلة علوم سياسية العددان 51-52 لصيف-خريف 2016.
6- أوروبا وحرب أوكرانيا الانخراط العسكري ودفع الاثمان الاقتصادية
أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا إحياء المخاوف القديمة في أوروبا، بعد اعتقاد طويل بأن القارة تجاوزت مرحلة الحروب الكبرى. إذ فتح استمرار القتال تساؤلات حول إمكانية امتداده إلى دول أخرى وما قد يترتب عليه من كلفة اقتصادية وأمنية عالية. وبالاستناد إلى ما ورد على موقع يورونيوز للكاتبة ديلّانا، أ.، ويلماز، م. ج. (4 أيلول/سبتمبر 2025)،تعكس البيانات حجم هذا القلق، حيث ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما فيها روسيا، بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 693 مليار دولار، متجاوزًا أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي مع استعداد الحكومات الأوروبية لضخ مئات المليارات الإضافية خلال السنوات المقبلة، متأثرة بهواجس التهديد الروسي وبالضغوط الأمريكية لرفع إنفاق دول الناتو الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي.وتكشف خطط عدد من الدول الأوروبية الكبرى عن تحوّل واضح في استراتيجياتها الدفاعية، التي باتت تُعدّها ضرورة ملحّة لضمان أمنها القومي في مواجهة أخطار قادمة من الشرق وربما من مناطق أخرى مستقبلًا.
بالاستناد إلى ورقة تحليلية صادرة عن مركز أبحاث البرلمان الأوروبي بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تخطط ألمانيا لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2029، بما يعادل نحو 195 مليار دولار سنويًا، خاصة وأن البلاد تحمل إرثًا عسكريًا ثقيلًا منذ الحرب العالمية الثانية. أما فرنسا، صاحبة أكبر قدرات عسكرية في أوروبا، فستزيد ميزانيتها الدفاعية بمقدار 4 مليارات دولار العام المقبل و3.5 مليارات في 2027، لترتفع من 38 مليار دولار عام 2017 إلى نحو 74 مليارًا في 2027. وفي إيطاليا، رغم كونها من أقل دول الناتو إنفاقًا بالنسبة للناتج المحلي، فقد رفعت ميزانية الدفاع هذا العام بأكثر من 12% لتصل إلى 37 مليار دولار، مع تأكيد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن هذه الزيادة لن تؤثر على البرامج الاجتماعية.
أما المملكة المتحدة، فقد التزمت بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.6% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، أي ما يعادل إضافة أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا لدعم قواتها المسلحة. في المقابل، تسلك إسبانيا مسارًا مختلفًا، رافضة دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي، معتبرة أن نسبة 2% كافية وأن أي زيادة إضافية قد تؤثر سلبًا على اقتصادها.
7- ترامب وغرينلاند: إعادة طرح سؤال الانسحاب الفرنسي من الناتو في ضوء السياسة الأمريكية المعاصرة
في كلمة ألقاها خلال منتدى دافوس الاقتصادي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 كانون الثاني 2026 الى بدء “مفاوضات فورية” مع الدنمارك حول اقتناء غرينلاند بحجة أهميتها للأمن الأمريكي والعالمي، مؤكدًا أنه لن يستخدم القوة للحصول عليها، وكما اورد موقع تايم الاميركي قال ترامب: “لا أريد استخدام القوة، ولن أستخدم القوة… كل ما تطلبه الولايات المتحدة هو مكان يُسمّى غرينلاند”، واصفًا الجزيرة بأنها “أراضينا” من منظور استراتيجي.
أثار هذا التصريح جدلاً واسعًا، خصوصًا بين حلفاء الناتو والدول المعنية، الذين شددوا على أن غرينلاند ليست للبيع وأن سيادتها يجب أن تُحترم. وفي هذا السياق، تناولت صحيفة «فيدوموستي» الروسية في مقال للكاتب أنطون أوسيبوف السجال المتصاعد حول مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مستحضِرًا سابقة تاريخية حين اتخذت فرنسا خطوة مماثلة قبل نحو ستة عقود.
وأشار أوسيبوف إلى أن تصريحات ترامب بشأن غرينلاند أعادت فتح النقاش حول تماسك الحلف وآفاقه؛ ففي وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي أن الناتو سيفقد الكثير من قوته من دون الولايات المتحدة، يدرس قادة أوروبيون خيارات لبناء ترتيبات دفاعية بديلة، فيما بدأ في فرنسا حديث علني عن إمكانية مغادرة الحلف.
وفي رد واضح على هذه التصريحات، أصدر قادة أوروبا، أبرزهم الرئيس الفرنسي ماكرون ، ورئيسة وزراء ايطاليا ميلوني، وغيرهم من القادة الاوربيين، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن الجزيرة الاستراتيجية «تنتمي لشعبها»، وأن السياسات المتعلقة بها يجب أن تُقرّر فقط من قبل الدنمارك وغرينلاند.
وجاء في البيان أن أمن القطب الشمالي يمثل أولوية للأمن الأوروبي والدولي، وأن حماية المنطقة يجب أن تتم بشكل جماعي ضمن إطار الناتو ووفق مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالسيادة وسلامة الأراضي واحترام الحدود. كما شدد البيان على أن الولايات المتحدة شريك مهم في هذه الجهود، لكن أي قرار بشأن غرينلاند هو شأن دنماركي وغرينلاندي حصريًا. هذا ما ورد على موقع تايم : تشوبانو، ك.، وداتسيو، س. (2026، 6 يناير). تصريح قادة أوروبا حول غرينلاند بالكامل بعد تهديد ترامب: «تنتمي لشعبها».
8- خاتمة
خلاصة ما تقدم من الأحداث والتحولات التاريخية الأوروبية منذ الحرب العالمية الأولى حتى الحاضر تُبرز نمطًا متكررًا من صراعات القوة، التغيرات الجيوسياسية، وأهمية الاستعداد الدفاعي. فقد أظهرت الحربان العالميتان هشاشة الإمبراطوريات التقليدية وعجزها عن الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية، وأثبتت أن الحروب الكبرى تتجاوز أثرها العسكري لتترك إرثًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل الأمد، كما في التدمير الشامل للمدن والبنية التحتية وتشريد الملايين.
ومع الحرب الباردة، بدا أن أوروبا الغربية أصبحت تحت مظلة أمريكية، لكن هذا التوازن شكّل أيضًا ساحة للتنافس بين القوتين العظميين، مع إظهار أهمية الجغرافيا السياسية في رسم السياسات والاستراتيجيات الدفاعية. أما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتوسع الاتحاد الأوروبي، فقد ظهرت تحديات جديدة تتعلق بالهوية الوطنية، التماسك الداخلي، والعلاقات مع روسيا، ما يبيّن أن الأمن الأوروبي لا يمكن فصله عن الديناميات الأوراسية الأوسع وأبعاد النفوذ العالمي.
في السياق الراهن، تعيد الحرب الروسية على أوكرانيا والتوترات المتعلقة بغرينلاند وصعود السياسات الدفاعية الأوروبية، التأكيد على أن أوروبا لا تزال في خضم إعادة تعريف استراتيجياتها الأمنية والسياسية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين التعاون الدولي والاعتماد على الذات، وتطوير قدرة دفاعية متكاملة لمواجهة التحديات المستقبلية.
محمد أحمد حمود / باحث في التاريخ
المصدر: موقع المنار