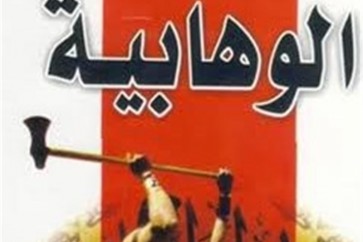الحقيقة المفتاحية لأي مجادلة حول الهوية الوطنية للدولة تقول: يندر، حد العدم، وجود دولة كاملة الاوصاف الوطنية. بكلمات أخرى، إن التطابق التام بين حدود الدولة وحدود الأمة بما يجعلها كياناً منسجماً بين مكوّناته السكانية (homogeneous society)، غير وارد في أي مرحلة من مراحل التاريخ.

في ضوء تلك الحقيقة، يصبح النقاش في مضمار آخر، بحسب حالة كل دولة، إذ ليس هناك وصفة معيارية تعين على إخراج ما في أقبية الهويات بكل مستوياتها (الخاصة والوطنية والقومية… الخ) من عناصر قوّة ووهن في كل المراحل، فالتفاوت في القوة والضعف يقولب، على الدوام ومن مرحلة لأخرى، هوية جماعة ما.
الوطن/ الأمة، بحسب تعريف ارنست رينان، هو الروح، المبدأ الروحي ويتألف من شيئين: الماضي والحاضر. الماضي بمعنى تقاسم إرث ثري من الذكريات، والحاضر بمعنى القبول الواقعي، أي الرغبة في العيش المشترك، والإرادة في الإعلاء من قيمة التراث، بوصفه قاسماً مشتركاً.
وهنا يصبح التفريق بين الوطن من جهة والقبيلة والعرق والطائفة من جهة، إذ إن الوطن يشكّل حاضنة لكل هذه المكوّنات، هذا حال فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهو حال البلدان العربية كافة بل وبلدان العالم قاطبة.وهناك دول تتحدّث لغة واحدة، وتعيش في إقليم واحد، ولكن لا يصدق عليها أوطان، لأن ثمة روابط أخرى مطلوبة: هي المشتركات الثقافية والتاريخية والاقتصادية والروحية، وهذا ما تعاني منه أغلب دول العالم.
وفي كل الأحوال، يرجع عجز الهوية الى سببين رئيسين:
ـ تكويني/ طبيعي، أي أن الدولة منذ نشأتها كانت حاضنة لأعراق، وقوميات، وأديان متعدّدة تحول دون بلوغها درجة الانسجام بالطرق الاعتيادية…
ـ فشل بشري ناجم عن إخفاق النخبة الحاكمة في تطوير برنامج إدماج وطني يفضي بمرور الوقت الى تطويع الهويات الفرعية (العرقية، القومية، الدينية…) لناحية صوغ وانضاج هوية كلية، وطنية جامعة، وصولاً الى اكتمال شروط الدولة الوطنية…
إن مكمن الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه النخب الحاكمة هو انشغالها الدؤوب في تحصين مركز السلطة، وإغفال البنية البيولوجية للدولة، بما هي كيان حيوي ثابت ودائم. وعليه، كان العمل جارياً على توفير عوامل المنعة لمركز السلطة بما يبقيه في مأمن إزاء الزوابع الشعبية بأشكالها كافة، وكان يتم ذلك في الغالب على حساب الدولة، بما هي الوعاء الأكبر للسكّان الذي يراد صهرهم فيه (melting pot) في سبيل تنضيج شروط الانسجام وصولاً الى بناء الدولة الوطنية الحقيقية الممثّلة لكل السكّان.
من بين الابتكارات التي تفتقت عنها أذهان النخب الحاكمة مفهوم «الاستعمار» الداخلي (internal colonialism) والذي يعود، حسب جون ستون، الى ثلاثينيات القرن الماضي حين جرى استعماله لتوصيف العلاقات بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة. وبرغم الجدل الثائر حول المصطلح نفسه، كأداة لتفسير ظواهر تاريخية كان فيها الاختلال سافراً بين القوى المتصارعة أو الغالبة والمغلوبة، إلا أنه لا يزال صالحاً لفهم، جزئياً على الأقل، لجوء النخب الحاكمة الى آلية كهذه لتحقيق الانسجام القهري عن طريق هيمنة منطقة أو فئة على كامل مساحة الدولة يتبعه تغلغل ثقافي وسياسي وأمني بما يفضي الى «تطهير ثقافي» أو «إبادة ثقافية» ناعمة.
وشأن كل أشكال التطهير الأخرى، فإن الاستعمار الداخلي أخفق في تحقيق الانسجام بين المكوّنات السكانية في أي دولة، وفشل، مآلاً، في بناء هوية كليّة جامعة. وفي النتائج، مهما بلغت قدرة النخبة الحاكمة على إرغام من ترى فيهم مصدر تهديد لوحدة واستمرار السلطة، فإن تجارب الأمم تزوّدنا بحقيقة مفادها أن فناء الجماعات كان ممكناً ضمن شروط نادرة للغاية، وهي اليوم لم تعد قائمة.
الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه النخب الحاكمة هو انشغالها في تحصين مركز السلطة
وفق هذه النتيجة، ينهض السؤال: ما هو، إذن، العامل المسؤول عن العجز الهوياتي في الدولة. الجواب ببساطة يكمن في طبيعة، وواقع، ورؤية السلطة لذاتها وعلاقتها بالمجتمع. إذ من غير الممكن الحديث عن هوية وطنية فيما النخبة الحاكمة تدير الدولة بناء على مدعيات لاهوتية، وتاريخية، وعائلية وعسكرية، وحزبية مستمدة من خارج المجال الوطني للدولة، أي ليست حاصل جمع مشتركات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية.
في التكوين التاريخي للدولة السعودية ما يستحق الفحص، لا سيما في خصوص ما نحن بصدده. إن الخطة التي عمل عبد العزيز آل سعود على تنفيذها حين قاد أول غزوة على الرياض سنة 1902، لا تظهر أي رؤية تاريخية أو فلسفية لمشروع دولة وطنية. إن الشعار الذي استوطن حملات ابن سعود كافة كان «ملك الآباء والأجداد»، وهو شعار لم يغادر أفواه أبنائه حتى اليوم. وعليه، فإن المدّعيات التاريخية والأيديولوجية المحرّضة على تعبئة الجنود على مدى ثلاثة عقود (1902 ـ 1932) لم يجر تجاوزها بعد إعلان المملكة السعودية، وإنما اكتست أردية أخرى، ولكن ليس من بينها الرداء الوطني.
وبعد أكثر من ثمانية عقود على قيام المملكة السعودية، لا تزال الهوية الوطنية تعاني عجزاً دائماً، ليس لأن مكوّني الهوية (آل سعود، والوهابية) للمملكة يقتصران، تاريخياً وجغرافياً وإدارياً، على منطقتي الرياض والقصيم، من أصل ثلاث عشرة منطقة إدارية، ولكن الأهم من ذلك هو عمل النخبة الحاكمة على ترسيخ الانقسامات الداخلية على خلفية مذهبية، قبلية، ومناطقية. ما يبعث على السخرية أن تلجأ النخبة الحاكمة الى عوامل الانقسام وليس الوحدة لمواجهة، ما تعتقده أو تتخيّله، تحديات محدقة بالدولة، وأن توجّه جزءاً من قوتها للداخل. ويمكن المجادلة، في ضوء فيض من الأدلة، بأن المنتج الاعلامي والثقافي والديني والسياسي في المملكة السعودية في الوقت الراهن هو نقيض الوطنية، ولا صلة له بتنمية الروابط المشتركة بين المكوّنات السكّانية. هو، في واقع الأمر، يسهم في إدامة العجز الهوياتي في المملكة، لأنه منتج غب الطلب لدى النخبة الحاكمة، التي ترى في وحدة السلطة وتركيزها وتماسكها أولوية متقدّمة على بناء الدولة الوطنية الحقيقية.
في عقيدة أوباما، كما صاغها جيفري غولدبرغ في مقالته لمجلة «أتلانتك» لعدد نيسان القادم، إشارة بالغة الدلالة، وإن مقتضبة، حول الدور التدميري للقبيلة في الشرق الأوسط. بلا ريب، فإن السعودية تمثّل النموذج الأبرز لنظام قبلي في الشرق الأوسط في سياق مجهودات متعثّرة لدى قوى سياسية واجتماعية حديثة كانت ولا تزال تسعى للانتقال بالكيانات السياسية القائمة من اللادولة الى الدولة الوطنية مكتملة النمو. أضاف أوباما استطراداً للقبلية نعتاً تهكمياً لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وهو «مستبدون أذكياء».
من جهة ثانية ذات صلة، إن العلاقة الحميمية بين «الهوية الوطنية» والمشروعية تفرض دائماً سؤال العلاقة بين النخبة الحاكمة والمكوّنات السكانية كافة. إذ لا يمكن الفصل بين الهوية الوطنية والمشروعية، كون الأخيرة تمثل الحاصل الموضوعي والطبيعي لنوع ومستوى العلاقة بين الحكّام والمحكومين، وهي ما يحدّد مشروعية الحكم وتالياً شكل الهوية التي تتمظهر فيها الدولة.
في التجربة السياسية السعودية، لم تكن الهوية الوطنية مكتملة في أي مقطع زمني، بل دائماً كانت في حال أزمة، تزداد حدّة وارتخاءً من عهد لآخر، ولكن لم تقترب في أي مرحلة من الحل، أي من كونها هوية جامعة. من وجهة نظري، فإن التوصيف الدقيق لهوية المملكة السعودية هو أنها هوية فرعية من بين هويات فرعية أخرى، ولكن مع فارق كونها هوية غالبة فحسب. لا تصبح الهوية الوطنية كذلك الا حين تكون مبعثاً مشتركاً وجماعياً للأفراد من كل التحدّرات الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية، أما حين تكون هوية الدولة حبيسة جماعة مغلقة وإن تسترت بمبدأ وطني فتلك دولة الجماعة لا دولة الأمة.
من المفارقات التاريخية والسياسية أن يكون الملك سلمان (تولى في 23 كانون الثاني 2015) هو من يدير دفّة (مملكة الآباء والأجداد) في زمن مفتوح على كل التشظيات الكيانية، وإعادة رسم الخرائط في المنطقة، وهو الذي ما فتأ يبشّر أهل دعوته وبني مملكته أن الوهابية ليست سوى مشروع إحيائي لتجربة الرسالة الأولى، وأن الدولة السعودية، بحسب محاضرة له في 30 آذار 2011، «أعادت للمنطقة الدولة المركزية القائمة على الدين مثلها مثل الدولة الاسلامية الاولى…». مقولة تختزل وتختزن الرؤية العقدية والتاريخية التي تحول دون قبول مبدأ المقاسمة، والشراكة، والخطأ وتفرّض ما يصفه أدغار موران (التملّك الاحتكاري للحقيقة)، وهذا ما قاله سلمان فصاحة «كيف نطالب بإصلاح مضامين الدعوة وهي تلك المضامين التي نادى بها القرآن الكريم والسنة النبوية؟» (انظر: سلمان بن عبد العزيز، فليحذر الباحثون من فخ مصطلح «الوهابية»، صحيفة «الحياة»، 28 إبريل/ نيسان 2010).
من بين المعاني التي يسترها مثل هذا الرأي، أن معتقدات المواطنين تصبح فاسدة في حال عدم تطابقها مع المذهب الرسمي، وتقع، في نهاية المطاف، خارج المجال المقدّس الذي يحتوي الملك وأهل دعوته. حينئذ، تصبح الهوية الوطنية عاجزة حكماً عن استيعاب أفراد الدولة لأن الأسس التي تقوم عليها ليست من سنخ الدولة، وإنما تنتمي الى حقل آخر، أي حقل اليقينيات الإيمانية.
إن النقطة المركزية لاندثار الهوية، أو بالأحرى الأسس التي يمكن توظيفها لتشكيل هوية وطنية، تكمن، إذن، في رؤية السلطة لذاتها، ومذاك يجاب سؤال التمثيل، أي من تمثّل السلطة، وما الأهداف التي ترجو تحقيقها. إن فشل المملكة السعودية في أن تتحوّل الى دولة وطنية هو المسؤول عن بقاء خطر التفكك محدقاً بكيانها على الدوام، وإن خطاب الانفلاش المعمّم حالياً إعلامياً ودينياً وثقافياً وسياسياً بقدر ما يشدّ عصب مركز السلطة فإنه، في الوقت نفسه، يهدر دم الدولة ويكشفها على أخطار التآكل التدريجي لأطرافها بفعل غياب سياسة إدماج وطني فاعلة أولاً، والعمل، في المقابل، على ترسيخ عوامل الانقسام انقاذاً للسلطة ثانياً.